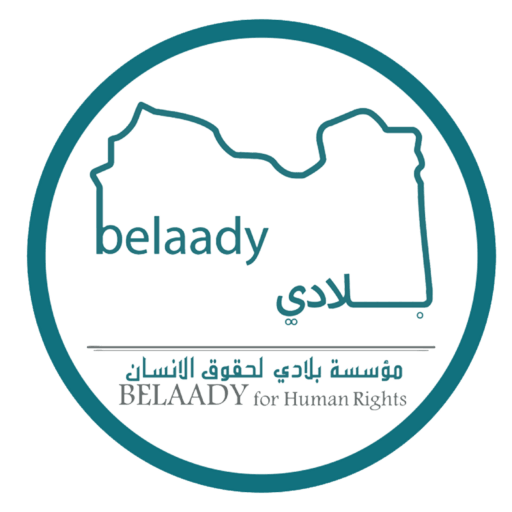كتاب صادر عن مركز القاهرة شاركت في كتابته مؤسسة بلادي لحقوق الانسان سنة 2011
في ذكرى السابع عشر من فبراير، أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كتابًا جديدًا بعنوان: “ليبيا ديموقراطية ضلت طريقها”، أعد فصوله الأربعة سبعة من الباحثين الحقوقيين والأكاديميين والسياسيين الليبيين. وكان المركز قد طلب منهم التفكير في معوقات التحول الديمقراطي في ليبيا بما في ذلك تلك التي تعرقل تطبيق اتفاقات الهدنة والسلام.
يسعى هذا الكتاب إلى سد فجوة بحثية حول تحليل الأوضاع في ليبيا، ويقدم قراءة حقوقية لطبيعة التحديات التي واجهتها ثورة السابع عشر من فبراير وما زال يعانيها كل مهتم بالشأن الليبي حتى الآن. فرغم توصل القوى الدولية المعنية بليبيا في يناير الماضي إلى اتفاق في مدينة برلين، إلا أن هذا الاتفاق سيبقى أسير لعلاقات قوى معقدة على أرض الواقع لا يمكن للمجتمع الدولي التغاضي عنها، وإلا سينتهي هذا الاتفاق لما آلت إليه عشرات المحاولات المحلية والدولية السابقة له.
وفي هذا السياق يتطرق الكتاب لأبرز أسباب انحراف المسار الديموقراطي في ليبيا، ويعيد نشر في خاتمته خارطة طريق توافقية بين بعض مكونات المجتمع المدني الليبي نحو حقوق الإنسان واستعادة حكم القانون في ليبيا، تقوم على احترام حقوق الشعب الليبي، والتصدي لإفلات الجناة من العقاب أيًا كانت مواقعهم، وإعلاء سيادة القانون على الجميع.
إذ شهدت المرحلة الانتقالية في ليبيا عجز تام عن إدارة أو رعاية أي حوار مؤسسي جاد بشأن أيٍ من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بشكل نظام الحكم ما بعد القذافي، وطبيعة العلاقة بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما فشلت في إدارة ملفات محورية كملف تنظيم الإعلام ومحاربة خطابات الكراهية والحض على العنف، وملف الهجرة غير الشرعية، وملف الأوضاع الخاصة بالنساء. ولعبت الجماعات المسلحة بمرجعيتها العسكرية والدينية والقبلية الدور الأكبر في توجيه مسار محاولات الإصلاح التشريعي، أو السياسي أو حتى مجرد الاتفاق على سلطة موحدة للبلاد تتولى إدارة شئونه، هذا بالإضافة إلى غياب هيكلة المؤسسات الأمنية على نحو مكّن المجموعات المسلحة المختلفة من عرقلة عملية السلام والتحول الديموقراطي وبناء دولة القانون. فبعد مرور 9 أعوام على هذه الثورة، مازالت ليبيا عاجزة عن تصميم عملية دستورية وتشريعية وسياسية رصينة تضمن انتقالها من المرحلة الانتقالية إلى مرحلة الاستقرار الديموقراطي.
يبحث الفصل الأول إشكالية نظام الحكم، من خلال وجهتي نظر. الأولى تنطلق من التأكيد على أن ثمة موروث مؤسسي متجذر في ليبيا ما قبل القذافي، يعتبر تجاهله أحد أهم أسباب فشل استرجاع الطابع المؤسسي للحكم والإدارة السياسية في ليبيا بعد الثورة. بينما تتبنى وجه النظر الأخرى أسباب مغايرة لهذا الفشل ترتبط في مجملها بحزمة من العوامل التاريخية والثقافية والاجتماعية كالشخصنة والقبلية والجهوية المرتبطة بالمجتمع الليبي، وتنفي عن ليبيا أنها كانت يومًا دولةً مؤسساتية حقيقية بمفهومها الديمقراطي المؤسساتي التقليدي المحايد المتعارف عليه دوليًا.
ولعل من أبرز انعكاسات هذه العوامل بعد 2011 كان الصراع المسلح، والذي طُرح خطأً من البداية باعتباره الآلية الوحيدة المتاحة للحل والوسيلة الأفضل لإحكام السيطرة على العملية السياسية في دولة هشة مضطربة اجتماعيًا تشهد تفتت أهلي واسع بسبب زلزال التغيير الذي هز أرجائها. لذا حاول الفصل الثاني رسم خريطة للجماعات المسلحة في ليبيا- بما في ذلك الجماعات العقائدية- وتحالفاتها ومواقعها من الأطراف الحاكمة، متتبعًا نشأة كل مجموعة حسب محيطها الجغرافي وانتمائها القبلي، ومراحل تغير مواقفها من القذافي، ومن ثورة 2011، ومن الانقسام بين حفتر وفجر ليبيا 2014.
هذا الصراع المسلح المحتدم فرض سؤال حول محاسبة الجناة وبلوغ العدالة كضمانة أساسية لتعديل المسار نحو التحول الديموقراطي مرة أخرى. لذا بحث الفصل الثالث العوائق التي حالت دون قدرة المؤسسة القضائية في ليبيا على القيام بهذا الدور، مسلطًا الضوء على منطق سياسي استحواذي على السلطة القضائية تبته جميع الأطراف السياسية المتعاقبة منذ الثورة وحتى اليوم، الأمر الذي أفقد السلطة القضائية مكانتها وفرّغ الأحكام من قيمتها القانونية الملزمة، بعدما صارت في كثير من الأحيان مُعطلة التنفيذ، وأفلت الجناة من العقاب واستمرت الانتهاكات بلا رادع. أما المؤسسات الإعلامية باعتبارها كفة الميزان الأخرى أمام السلطة القضائية في مواجهة ثقافة العنف واحتدام الصراع، فقد كان تطرق المبحث الثالث لها منصبًا أيضا على بحث أسباب فشلها في القيام بهذا الدور، بل على العكس توظيف المؤسسات الإعلامية الليبية كأحد أدوات الصراع، تستخدمها الجماعات المتناحرة في نشر خطاب حاض على الكراهية والعنف يؤجج الصراع ولا يسعى لتهدئته.
وفي الفصل الأخير حاول الكتاب أن يلقي قليل من الضوء على بعض ضحايا هذا الصراع المحتدم، الذي تدفع ثمنه قطاعات واسعة في المجتمع الليبي، اختار منهم المهاجرين والنساء. إذ ثبت أن التشكيلات المسلحة تستغل (المهاجرين) في بناء مقراتها وسجونها وتجهيزها وتوسيعها وتنظيفها. هؤلاء الهاربون من جحيم الفقر والنزاعات يغامرون بحياتهم وأطفالهم قبل أموالهم وجميع مدخراتهم، ليجدوا أنفسهم في تيه الصحراء الليبية أو في سجونها ومخازنها حيث كل صنوف التعذيب والقتل البطيء، أو ينتهي بهم المطاف في يد عصابات مسلحة لها باع في سوق بيع البشر والتجارة بهم. أما المرأة الليبية فتعد الضحية الأولى والأساسية لهذا الصراع الممتد، فهي المكلومة والثكلى والأرملة واليتيمة. وهي رهن الخطر ليس فقط أثناء ممارسة عملها كحقوقية أو برلمانية وإنما لمجرد ممارستها حياتها بشكل طبيعي. ففي مخيمات النازحين واللاجئين تُنتهك كرامتها الإنسانية وتتعرض للاعتداء البدني والجنسي، وفي معظم المدن تتعرض للخطف لطلب الفدية أو للهوية، وخوفًا من ذلك كله تُحرم من الخروج لقضاء احتياجاتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومن الدراسة ومن العمل وحتى من الرعاية الصحية. وتتسع دائرة معاناة المرأة الليبية من التمييز بممارسات وتشريعات وأحكام تعسفية تنطلق تحت ستار الوازع الديني، وتدافع عنها جماعات دينية- في معظم الأحيان مسلحة.
الزهراء لنقي، طارق لملوم، مروان الطشاني، جازية جبريل شعيتر، رضا فحيل البوم وآخرون